كان للقبول الحسن الذي لقيه ما كتبت عن كشف المجهول القابع في ردهات النسيان تشجيع في الاستمرار ومحاولة مخلصة لتكريس الهوية الكويتية وبلورتها، وفي الوقت نفسه الاعتزاز بالموروث الذي حفل بمسيرة بناة ومصلحين عجت به نخب متعددة الكفاءات. وعدت فأنجزت، أخلصت فأوفت. إن الكتابة في هذا الشأن هي وضع الامور في نصابها منعا للخلط واللغط ونحن نغربل التاريخ بغربال منسوج بالوثيقة والمعقول، فما سقط منه تركناه وما بقي اخذناه. فليس من العجب ان يكون مثلي من يبحث عن تاريخ قومه ويتعلم من مبادئ اجداده ويتدارس معالي همهم، وكأنني بطرفة بن العبد حين قال: وقص الحديث على أهله فان الوثيقة في قصه ولا تذكر الدهر في مجلس حديثا اذا كنت لم تحصه في الحلقة الثالثة والاخيرة يكمل الكاتب يعقوب يوسف الابراهيم البحث في تاريخ شخصية كويتية تعتبر من طلائع طلاب العلم. وفي عهد سعيد باشا صدر قانون يمنع طباعة الكتب التي تتعارض مع تعاليم الدين وسياسة الدولة ومصالحها، كما يفرض الحصول على اجازة الطبع من نظارة (وزارة) الداخلية مع تفاصيل محتوى الكتاب وعدد النسخ، اما القانون الذي صدر في عهد توفيق باشا فكان صارما ومعرقلا لحركة النشر حيث فرض رسوما مالية. وقد غادر الكويت في منتصف الستينات من القرن التاسع عشر بحرا على احدى السفن (بغلة) العائدة الى آل ابراهيم تحمل تمورهم الى موانئ اليمن والحجاز، حيث كان الشيخ عبدالله بن عيسى آل ابراهيم مقيما بين جدة ومكة المكرمة آنذاك، فمنازل آل ابراهيم في مكة المكرمة تسمى حوش الكويتيين وموقعها على طريق السيل قرب سوق حراج الخردة حاليا، وصل ماجد الى جدة واقام فترة من الزمن هناك للسفر الى مصر لان مشروع قناة السويس لم يكن منتهيا آنذاك وحركة السفن الى موانئ شمال البحر الاحمر قليلة لان الطريق الى اوروبا لم يكن سالكا بعد ولم تفتتح قناة السويس الا عام 1879. تم طبع الكتاب وعنوانه ‘نيل المآرب في شرح دليل الطالب’، قام ماجد بهذه المهمة خير قيام وانتهى منها في شهر رمضان عام 1288 ه المصادف عام 1871م ابان حكم الخديو اسماعيل وهو اول كتاب طبع على نفقة كويتي بل يمكن القول انه اول كتاب طبع في الجزيرة العربية والخليج عموما، مما يعطي الريادة للكويت في هذا المجال، فكان مفصلا في اذكاء مسيرة التنوير وتعزيز شأن طلائعها الاوائل، وهي مآثر تميزت بها الكويت حين ارست اولى لبنات مدماكها في البناء الثقافي والفكري فوضعها على رأس من اهتم بمجال نشر المعرفة، وعلى الرغم من ذلك فانه من المحزن ان هذا العمل الرائد لم يحظ باهتمام القائمين على تسجيل حركة الثقافة عندنا ‘ومن باع درا على الفحام ضيعه’. ****** مدافع نابليون والطباعة لابد هنا ان نتوقف قليلا ثم نعرج على تاريخ هذا المرفق الحضاري: ‘الطباعة وصناعة الكتب’. ‘إن المقولة بفضل الحملة الفرنسية على مصر 1801-1798 واستيقاظ العرب على جلبة عربات مدافع نابليون التي تجر خلفها مطبعة حديثة فيها الكثير من المبالغة. فالحقيقة الغائبة تزخر بمفارقات حول أول مطبعة عرفها الشرق العربي وهي التي أنشأها الشماس عبدالله زاخر الحلبي في دير يوحنا الصايغ في قرية الخنشارة في جبل لبنان عام 1732 وقبل ذلك انشأ البطريرك اثنا سيوس دباس الرابع حوالي عام 1705 في حلب وطبع فيها كتاب ‘المزامير’ ولكن انتاجها اقتصر على طباعة الكتب الدينية المسيحية. أما السبب الأصلي لدخول المطابع في الشرق الادنى عامة فكان في الاستانة حيث سبقت الدولة العثمانية دول المشرق كلها الى معرفة الطباعة في نهاية القرن الخامس عشر على يد احد رجال الدين اليهود واسمه اسحق جرسون الذي احضر معه مطبعة وحروفا عبرية عام 1485 فأجازها السلطان بايزيد الثاني لكنه أصدر امرا بمنع استعمالها لغير اليهود ويومها كان نفوذهم عنده كبيرا. بعد ذلك انتشرت مطابع الرهبان اليسوعيين في جبل لبنان التي جهزت بالحروف العربية والسريانية ثم اتى المبشرون المسيحيون الاميركيون فنقلوا مطبعتهم من مالطا الى بيروت. اما الطباعة في مصر فقد ظهرت مع دخول الحملة الفرنسية كما اسلفنا حيث كان نابليون يؤمن بقوة المطبعة والمطبوعة وتأثيرهما في الملأ. وقد ابتدأ عمل تلك المطبعة وهي على ظهر السفن في البحر تشق عبابه بطريقها الى مصر لتطبع النداء الموجه الى اهلها بالعربية وتطمئنهم الى مقاصد واغراض الحملة في رفع الحيف والظلم واقامة مجتمع مبني على مبادئ الثورة الفرنسية بالاخاء والمساواة والحرية. فكان عمل المطبعة الحقيقي هو ملازمة النشاط العسكري. وما ان تولى الامور في مصر محمد علي باشا، كما اشرنا، فكر في ادخال الطباعة عام 1815 واسس فعلا المطبعة المصرية في بولاق عام 1820 لطباعة ما يلزم من احتياجات الجيش المصري الحديث والذي ابتدأ تكوينه بالاستعانة بالضباط الفرنسيين الذين شاركوا في حملة نابليون وابتدأ في تنظيم البلاد بشق الترع وزراعة القطن والذي اصبح، بعد مقاطعة بريطانيا للقطن الاميركي نتيجة حرب التحرير، أكبر صادرات مصر وساعد كثيرا في مشاريع تحديثها وتأسيس جيش للدفاع عن مكتسبات دولة حديثة بل تعداها الى خارج حدود مصر فقضى على الحركة الوهابية بنجد وحركة الانفصال في اليونان والتوسع في السودان حتى منابع النيل وبحيرة فكتوريا في اواسط افريقيا ثم الامتداد في سوريا وفلسطين وجزء من الاناضول لفترة قصيرة حتى وصل بقيادة ابراهيم باشا على بعد 200 ميل من اسطنبول عندها تدخلت بريطانيا وفرنسا في ايقافه فقبلها شرط ان يتولى وذريته حكم مصر. وقد بلغ ابراهيم باشا من الشهرة، ان دعاء الفلاحين في صلاة العشاء في جنوب تركيا كان يتضمن ذكره: اقسما مورمت حكومتي نصرت صباح بنيت كيسمزي بركت اغاميزا برت كالموزة قوت ابراهيم باشا رحمت اغاميزا برت باي قامنبيزي صلوات ****** ان الحديث عن المطابع وتأثيرها في وعي المجتمع في الكويت الذي وان كان بعيدا بالمسافة، فإنه قريب بالطموح والرغبة ولم يكن الاهتمام بالكتب وجلبها غريبا عن اهلها فكان اكثرها مطبوعا في مصر، لان انتاج البلاد العربية الاخرى خاصة بلاد الشام كان مقتصرا على المطبوعات الدينية المسيحية كما اسلفنا فأصبح الاتجاه الى مصر جبريا والتطلع نحوها احاديا. ****** سبق ان اشرنا الى بدايات التعليم في الكويت واهتمام الموسرين من اعيانها بتعليم ابنائهم وابناء اقاربهم واصدقائهم ومعارفهم في مدارس خاصة تلحق بمجالسهم ودواوينهم، والمدرسة ليست مجموعة من ابنية او سلسلة دروس بل هي تجربة في التدريب مادتها النشء الذي لم يكتمل والهدف هو تربيته وتعليمه وغرس روح الانضباطية والمثابرة، لكي يتمكن من ان يبلغ مرحلة الشباب مسلحا ناضجا لخوض معركة الحياة، فالمحاولة هنا -فوق كل شيء- هي تجربة انسانية متعددة المراحل وهي في الحال نفسها تأثير عقل في عقل، فلا يمكن ان تتحقق الا ان تكون في محيط من الانفتاح والانضباط المعقولين ويبقى الفرق واضحا بين تعليم الترف وتعليم المسؤولية، عندما يعطي الغرس ثماره وترى حصاده كوكبة من الشباب الذي يؤدي دوره في مستقبل الايام وما يعطيه هذا الدور من خدمة للبلد والمجتمع. مدرسة آل ابراهيم مثل ما تقدم كان في مجلس آل ابراهيم مدرسة خاصة ابتدأت عام 1255 – 1845 ولم يكن التعليم فيها محصورا بالفتيان داخل الكويت من الخاصة والمعارف، بل امتد الى خارج الكويت، ولنر ما كتبه المؤرخ مقبل عبدالعزيز الذكير الذي درس في مدرسة آل ابراهيم الخاصة قادما من عنيزة في اقليم القصيم بنجد مع بعض من اقرانه، ففيه امر وتميز جعل ابناء تجار موسرين هناك اختيار القدوم الى الكويت وبالذات المدرسة الآنفة الذكر، وكان بامكانهم ارسال ابنائهم الى مدن اخرى في بلدان لهم فيها علاقات تجارية كالبصرة وبغداد والبحرين والاحساء. يقول الذكير -الذي كان في الكويت حوالي عام 1313 ه – 1896 م وكان شاهد عيان لحوادث محورية حصلت آنذاك ذكرها- في مخطوطة ‘مطالع السعود’: ‘وصلت الكويت مع خالي مقبل العبدالرحمن الذكير من عنيزة في 25 ربيع الثاني 1313ه وعمري وقتذاك اربعة عشر فأبقاني خالي في بيت الشيخ يوسف بن ابراهيم للتعلم والكتابة، فافردوا لي حجرة خاصة في المجلس وجرت الحوادث كلها وانا في البيت المذكور، وكنت بمعية عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن علي بن ابراهيم، وكان يومئذ في الكويت ومصطفى ابن الشيخ يوسف وكنا في سن واحدة فصحبناهم في الدراسة والقنص ومعنا من ابنائهم واقاربهم واصدقائهم آخرون، وكذلك معنا حمد بن عبدالله الخنيني من عنيزة ايضا’. ومن معلمي المدرسة كان ماجد بن سلطان الذي اكمل تحصيله في القاهرة كما مر، والذي يعتبر من المصلحين الاجتماعيين مثله مثل من قاد حركات التغيير في ذلك العصر. وكانت حياته نشيطة وفعالة وحركة لا تهدأ تمتعت بما ذكره عنه من عرفوه، صادق في عمله لا يكل الا بعد تحقيق اهدافه كثير التأمل والتساؤل حتى اصبح قريبا من احداث بلده التاريخية والمفصلية في منتصف اواخر القرن التاسع عشر. وفي الوقت نفسه كان محببا لمن عرفه او تعرف عليه اينما حل، فيلقى الاستحسان بسرعة لمواقفه وانسانيته ومشاعره المخلصة. وكان عطشه الذي لا يرتوي لإحقاق الحرية والعدالة فوطنيته هي السبب الذي جعله ساخطا على العمل المشين فأخذ جانب الشرعية في ارجاع الحقوق، فكان جنديا شجاعا وهو يخوض هذه المعارك ولم يترك حكمة اخلاقية او سياسية او ميثاقا من دون ان يتوسده، فحياته كوطني ومثقف ومعلم ومصلح تظل معلما شاهدا ومثلا مضيئا. اهميته التاريخية ظهرت لانه كان شاهدا ومشاركا لامور مفصلية نقلها، كما يفعل بتعبير هذا الزمن ‘المراسلون’ في الصحف في مكان وزمان الازمات. وكان قادرا على التقاط الاحداث وتفسير الكيف العام ومزاجه في تعليقاته واحاديثه لمن يلتقي معهم. فالكويت كانت حبه ومصدر تعلقه ومن خلال شؤونها وشجونها، اضحى موقفه حازما فيما يخصها ولا مجال للتنازل في هذه التفاعلات الانسانية التي اصبحت واضحة للعيان بقدر ما يتعلق الولاء غير المحدود لها طوال سني حياته. كان معلما من الطراز الخاص فلم تكن القسوة من طبعه وهو الانسان المنصف لا يغضب بسرعة، لكنه انضباطي في تصرفه. على قدر هائل من التواضع مثل كويتيي ذلك الزمن، ولكنه تواضع ممزوج بالرفعة، يتماهى مع اللحظة التاريخية فهو رجل بامتياز، لم يكن رجل مشروع بل كان مشروعا في رجل لقد اراد المستحيل فضاع منه الممكن. كذلك شارك في التدريس معه مثقفو الكويت آنذاك مثل الاستاذ عبدالوهاب بن عبدالله بن احمد الطبطبائي 1873 – ،1957 وهو كاتب صحافي واديب راسل الجرائد المصرية التي نشرت في نهاية القرن التاسع عشر مقالات عن احداث الكويت ومنها جريدة اللواء التي كان صاحبها الزعيم المصري المعروف مصطفى كامل، وجريدة المؤيد التي كان يصدرها يوسف الازهري. كما كان من جملة من درس فيها رجال دين قصدوا الكويت لاداء رسالة العلم والثقافة، فأقاموا بها فترة مثل الشيخ محمد بن رابح، المغربي الاصل المكي المولد، درس على كبار علمائها ثم سافر الى عمان لتدريس ابناء حكامها ومنها الى الكويت حيث قام بالمهمة نفسها، ويذكر عبدالعزيز الرشيد في تاريخ الكويت ‘ان الفاضلين عبدالوهاب الطبطبائي ومحمد بن رابح غادرا الكويت بعد مقتل الشيخ محمد وشقيقه جراح الى الزبير’. استمر بن رابح بالتدريس في مسجد مزعل باشا في الزبير ودرس عنده الشيخ عذبي المحمد الصباح وعبدالمحسن البابطين (قاضي الكويت لاحقا) وعبدالحميد الصانع (صاحب ومدير تحرير مجلة كاظمة)، كما كان من جملة المعلمين عبدالوهاب الغرير الذي درس عند السيد احمد سيد عبدالجليل الطبطبائي وحمد العزيز كاتب الشيخ محمد الصباح وعلي بن عمار أول معلم للحساب. لقد كان تأثير المعلم ماجد بن سلطان بن فهد كبيرا في تربية ابناء الاسرة، فبناء على توصية منه فكر بابتعاث شباب اسرة آل ابراهيم لمتابعة الدراسة العالمية في الازهر بمصر وتبنى الأمر الشيخ يوسف آل ابراهيم ورشح حفيده داود واحمد بن مشاري آل ابراهيم. ولولا الاحداث وتولي الشيخ مبارك الحكم لتحقق الامر. تبرع الشيخ جاسم وربما كان هذا التأثير في مجمله ما تم بعد حوالي عقدين من الزمن، حيث تبرع الشيخ جاسم آل ابراهيم ببناء كلية دار الارشاد والدعوة في القاهرة باشراف المصلح الديني وتلميذ محمد عبده السيد محمد رشيد رضا في 1911. وكان الرئيس الفخري لمجلسها (راجع جريدة المنار 30 مارس 1911ج الثالث مجلد 14 ص196-191)، تلك الكلية التي حاول الدراسة فيها مؤرخ الكويت عبدالعزيز الرشيد. يذكر الدكتور يعقوب يوسف الحجي في كتابه ‘عبدالعزيز الرشيد ودوره في الحركة الأدبية والثقافية’ ص :8 ‘ولم يكتف الشاب عبدالعزيز بما حصل عليه من العلم في بغداد فقرر السفر الى مصر لكي يلتحق بدار الدعوة والارشاد التي اسسها صاحب المنار السيد محمد رشيد رضا في القاهرة. ولكنه ما ان وصل الى القاهرة وطلب الالتحاق بهذه الدار حتى رفض طلبه’. ويعلل ذلك: ‘ربما كان مستواه التعليمي عاليا ولا حاجة له للالتحاق بالمدرسة التي اسسها محمد رشيد رضا لمساعدة طلاب العلم في مختلف الدول الاسلامية. فترك مصر في طريقه الى الحجاز، حيث زار الاراضي المقدسة والتقى العديد من علماء العالم الاسلامي الكبار، ولما أتم مناسك الحج قرر ان يجاور في الحرم المدني وامضى قرابة عام في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ويتعلم حتى عاوده الحنين للأهل والاصدقاء فترك المدينة وعاد الى الكويت، وكان قد بلغ 26 عاما في 1913. فيكون الرشيد بذلك من جملة الكوكبة الثانية في طلائع المتنورين الذين قصدوا مصر وان كانت فترة اقامته قصيرة جدا، وقبله كان احمد بن الشيخ خالد العدساني (قاضي الكويت) الذي ارتحل بصحبة يوسف بن عيسى القناعي الى الاحساء فقرأ هناك ثم رحل الى الهند فأقام في بومبي واتقن تصليح الساعات فأثار ذكاؤه اعجاب الموسرين من اهل الكويت ونفذوا رغبته في اكمال الدراسة في مصر، فتوجه اليها من الهند عام 1324ه ومكث فيها فترة قصيرة لم تمكنه من الاستمرار في الدراسة، فرجع الى الحجاز ودرس عند رجال الدين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وما لبث أن اعتلت صحته حيث كان يعاني من مرض عضال في بطنه فرجع قاصدا اهله ووطنه فوافته المنية بعد وصوله الى الكويت بيوم واحد عام 1426ه1908-م. ****** ثقافة ماجد دعنا نرجع – عزيزي القارئ – ثانية بعد تغريبة لا بد منها الى قلب الموضوع، وقطب الرحى فيه: ‘المعلم ماجد بن سلطان’، ونقلب اوراق اجندته الشخصية لنرى ان تكوين ثقافته كان بجهد فردي وقراءته الشخصية بالاضافة الى اختلاطه بالعلماء والوجهاء وتحاوره الفكري والاجتماعي معهم، وتحاور العقول هو تلقيحها لرجل واثق من نفسه في مجتمع بادله الثقة، يكرس وقته للعلم والبحث وكانت أبواب ذوي الأمور مفتوحة له في أي مكان يحل. فهو المعلم والأديب الباحث الراغب في اختراق آفاق جديدة، مستعيدا ما يشبه الفردوس المفقود الذي يحن اليه الناس ويحلمون بولوج ابوابه للتمتع بحالة تتلخص بقيم الخير ومسالك الحق. في خضم هذا التوجه ارتأى الانصراف الى قضايا يعتبرها الأهم من حيث التداول حتى وان كانت من باب الذكرى التي ‘تنفع المؤمنين’، ديدنه الابتعاد عن التطرف بكل أشكاله. وقد انكب على تسجيل الكثير من الوقائع والتفاصيل والتطورات التي اجتاحت المشهد المحلي بعنف غير معهود على الرغم من وجود خلاف طغى على السطح، وكاد يكون شبه معلن بين اطراف قمة الحكم، فعاش المعلم ومعه كوكبة من المثقفين المتفتحين في ليل حالك كثر فيه حرقه وزاد أرقه، وطال سهاده فطار رقاده. كما وصفه أمير الشعراء: لا السهر يطويه ولا إغفاء ليل عداد نجومه رقباء فقرر الهجرة والالتحاق بالركب الذي غادر مضطرا متجرعا عذاب البعد عن مسقط الرأس، والحكم في هذه الامور على مثل هذا القرار هو في تصور بعض الفقهاء: ‘لصاحبه اجر مجاهد في حرابه’. اما الرومانسيون فلهم في تفسيره قول الشاعر: ففراق يكون فيه دواء او فراق يكون منه دواء ومن أمثال ماجد بن سلطان كان الركب يضم من المتنورين، كما اسلفنا، السيد عبدالوهاب الطبطبائي والشيخ محمد بن رابح ومحمد بن حسن الاحسائي وعلي بن عمار (استاذ مادة الحساب التجاري)، وبعدهم محمد أمين الشنقيطي وحافظ وهبة وسيد هاشم الرفاعي، ولحقهم بعقود عبدالله علي الصانع غادروا الكويت طوعا او قسرا، فهم كما قال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه): ‘منهم بين خائف مقموع وساكت مكعوم’ و’الكعم’ في لسان العرب هو ما يوضع على فم البعير ليمنعه من الاكل والعض. استمر هذا الجو المكفهر، الذي لا يستسيغ الرأي الآخر والسماع الى مظلوميته، بقرارات احسنها تعسف ومناكفة وفي أسوئها ظلم وحروب، ولم يفلت من ذلك التوتر حتى لحق مصادر الرزق فطال طبقة التجار بتلك الشواظ على الرغم من استكانتهم والرضوخ لسياسة الأمر الواقع مما دعا رموزهم إلى اللجوء إلى مسلك المثقفين أنفسهم، فأصيبت البلاد بمقتل حتم الا يكون مناص للحاكم إلا التراجع، فتم ذلك بعد تنازلات، لم تمنح للمثقفين والمتنورين لعدم الإيمان بهم أصلا، وان لم يكن ذلك التطمين مريحا، وبقي كحالة راكب السبع: إذا تمسك بالبقاء أنهكه العدو، وإذا سقط أرضا كان لقمة سائغة. يقول حافظ وهبة في كتابه ‘جزيرة العرب’، ‘قلما يعتني الشيوخ بتعليم أبنائهم وتثقيفهم ولا يعتنون إلا بالرماية والفروسية والصيد والقنص وبعضهم يرى طلب العلم عيبا لأنه قرين الجمود’. ومثله يقول القناعي عن عدم الرغبة في العلم، ويذكر الرشيد انه لم يعرف عن تقريب للعلم والعلماء إطلاقا . غادر المعلم ماجد بن سلطان الكويت في ربيع عام 1896م ملتحقا بالشيخ يوسف الإبراهيم وأبناء المقتولين ومن تبعهم من أهل الكويت، ثم سافر في مهمات كلف بها إلى بغداد مصطحبا الشيخ سعود بن محمد الصباح لمقابلة مشير بغداد رجب باشا، ثم اتجه إلى الاستانة وبعدها الى القاهرة، مشجعا الصحافي المصري بيومي ابراهيم لتقصي الامور في الكويت، فتم ذلك ونشر عدة مقالات في جريدة الاهرام امتدت بين سبتمبر ونوفمبر عام 1902 بعد معركة الصريف، ورجع إلى البحرين وقطر وحائل، وبعد وفاة الشيخ يوسف عام 6190 رجع إلى البحرين وأقام فيها فترة أخرجته السلطات الإنكليزية بعدها، فغادر إلى عمان وتنقل بينها وبين زنجبار متمتعا بضيافة البلدين ورعاية حكامهما، وبعد وفاة الشيخ جابر المبارك عام 1917 قرر الرجوع إلى البصرة مدعيا العلاج وكان همه نشر كتابه عن أحداث الكويت وحياته في الخليج بعد هجرته، وفي البصرة وعند دخوله ألقت القبض عليه سلطات الاحتلال البريطاني فيها حينما وجدت بحوزته وثائق ورسائل ومخطوطته التي لم تنل استحسانهم، فتم استجوابه ثم ألقي به في السجن، ولم يكن بسن تسمح له تحمل ذلك المصير فمرض وساءت حالته فانتقل إلى جوار ربه مأسوفا عليه وعلى أمثاله من محبي الكويت المخلصين، فمات الكتاب مع صاحبه في السجن أيضا ودفن في مقبرة الحسن البصري في الزبير، كما دفن فيها قبله من النوابغ عبدالله الفرج وبعده السيد هاشم الرفاعي. بموته ضاعت فرصة ذهبية في كتاب كان مؤلفه شاهد عيان وقريبا من الحدث وأصحاب القرار، وبعدها بفترة من الزمن أتلف الشيخ محمد بن رابح ما كتبه عن الفترة نفسها (راجع كتاب تاريخ الكويت – عبدالعزيز الرشيد)، وكان أيضا شاهد عيان ملما بدقائق الأمور وتفاصيلها. هذه مشيئة الأقدار، فذهب جزء من تاريخ الكويت لايزال اللغط مصاحبا له إلى يومنا هذا. راح واختفى كما تختفي المياه برمل الصحارى، ولكن قلوب الرعية تضل الخازن لتاريخها لتظهر الحقيقة كقطرات الندى على أوراق عشب الربيع لتروي الذاكرة ‘وان لم يسقها وابل فطل’. لقد حان الوقت لكشف وإزالة الضبابية عن مسلكه، وهي فرصة ثمينة لا تعوض. فللرجل تأثير كبير شئنا ام ابينا، لما تركه بوضوح لدى الناس، والاماكن التي تنقل فيها فأحبه اهلها لصراحته المعهودة التي هي علامته المميزة، طبيعية في كينونتها وبلا تكلف لتصبح شهرة تسبقه اينما حل. جاء الى الازهر ليدرس فقه الشريعة وينشد العدل ولا شيء سواه، كبير القلب متسلح بأفكار نبيلة، حالم بتغير العالم الى الأفضل وان لم يفلح فهو ليس نادما على شيء لانه لا يهدف من وراء ذلك الا خدمة الناس، فهو بطبيعته متفائل متصالح مع نفسه بعيد عن الانانية، ولم يكن بائع احلام او اوهام غير مؤمن بثنائية السيد والعبد، فكل همه كان انسانيا من الدرجة الاولى وتظل العدالة نصب عينيه، وان كانت احيانا حلما ينشده، كان مصلحا، دوره مكمل لما قام به من هم قبله، في تواضع العلماء الذين يجدون في المعرفة جسورا لايصال رسائلهم، وبقي داعية حرية لآخر يوم في حياته. بحثنا هذا تكريما إلى رجل لم ينل حقه حتى يومنا هذا، عمل الكثير من دون مقابل حيث لم يكن هناك مقابل أصلا غير حبه للخير وارضه، دفع من كيسه وعرقه ودمه لبلد يكرم فيها الآن من تقاضى المراتب والرواتب، ومن عاش ربيع النفط وربوعه وريعه. حقا انها نهاية جهود عالم ضاعت بين جهال. مثقف اختفى ذكره بمرور الزمن. ومع كل هذا تبقى أهميته كاسطورة، لأن حياته واعماله وابداعاته وسيرته منسوجة في احداث القرن التاسع عشر. منازل آل إبراهيم في مكة تسمى حوش الكويتيين أول كتاب طبع على نفقة كويتي كان للشيخ علي بن محمد آل ابراهيم
التاريخ اذا حكي (3), القبـس, 22 يونيو 2007

3920 اجمالي الزيارات 1 الزيارات اليوم
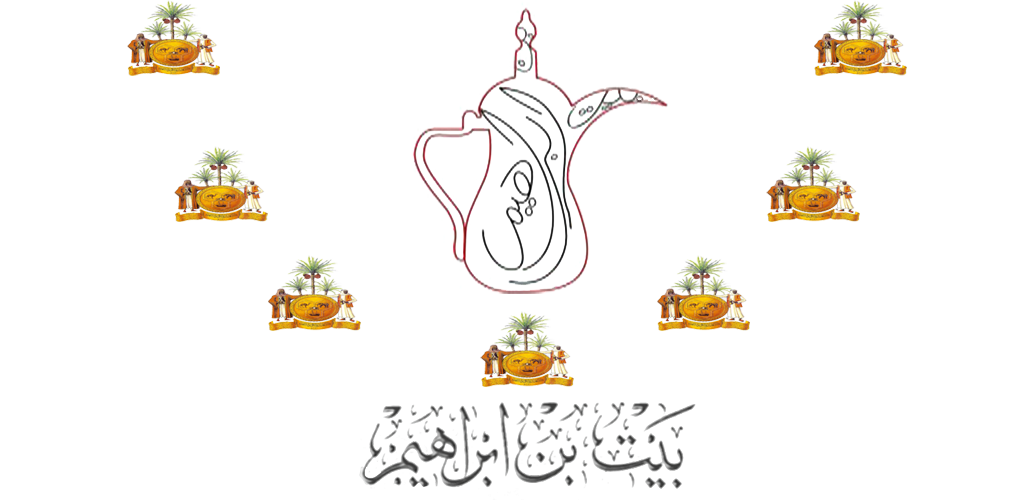
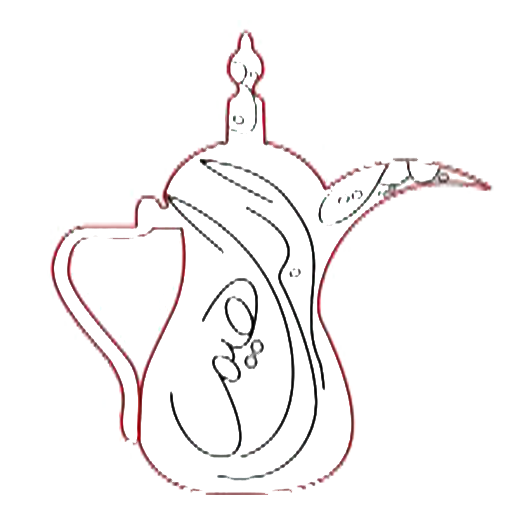

تعليقات الزوار